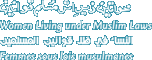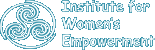حضرة المتهم أبي
سألته مرّة ان كان يمانع أن أكتب عن تجربته فقال “أي تجربة؟“، قلت له “تجربتك في الحرب الأهلية“، فردّ بسرعة بعينين شبه عابستين: “أنا ما شاركت بالحرب الأهلية“. ضحكت أمي وقالت بلهجة ساخرة: “انت ما شاركت بالحرب الأهلية؟!”. سؤال استنكاري دفع به الى اطلاق شبه ضحكة. أبي لا يعتبر نفسه مشاركاً في الحرب الأهلية، على الرغم من أنه قضى نصف عمره حاملا الكلاشينكوف بين زواريب “الغربية” و“الشرقية” تحت أزيز الرصاص، والنصف الآخر قضاه يدفع ثمن النصف الأول.
فهمت أنه لا يحبّذ أن أكتب عن الأمر، لكنني بعد سنتين على تلك الحادثة، أدرك كم أن تجربته هي تجربتي، وكم أنها متأصّلة في حاضري كما في ماضيّ، كم أني أشعر بضيق خانق عنما أرى زاروباً معتّماً فيه صور للأموات وأعلاما للأحياء، أو عندما أرى أمهات المفقودين والمعتقلين، أو عندما تقع “أحداث” 7 أيار، أو كلما رأيت رجال الدولة على التلفزيون، أو كلما أخبرتني أمي كيف كانت تنتظر أبي لليال طويلة فيأتي ببنطلون ممزق علق فيه شوك البراري.
لم تتَح لأبي الكثير من الفرص. لم يتخرج بشهادة جامعية، ولا ورث شركة كبرى عن والده، ولا هاجر الى أستراليا، لكن الحرب الأهلية أتيحت له، وككثير من أترابه، لم يفوتها.
أبي رجل بسيط وفقير وشديد الذكاء. أورثني لون شعره، و كثيرا من طباعه، وبنية جسده العضلية. علمني، على الرغم من اعتراضات أمي المتواصلة، أن العالم لا ينتهي اذا ما تغيبت ليوم عن المدرسة كي أستمتع بفطور صباحي معه في احدى المقاهي المشمسة، وأن لي حرية اختيار حذاء يومي هذا، وأن اذا ضربني “أحمد“، علي أن أرد له الضربة في اللحظة نفسها. وعلمني من بين ما علمني، ألا أدفع بقدمي الى ماسح الأحذية، بل أن أخلع حذائي وأقدمه له.
في الاجتياح الاسرائيلي الأول للجنوب، هرب أبي مع عائلته تاركين دكّانا صغيراً تركه لهم جدي قبل أن يموت حين كان أبي في العاشرة من عمره. جاؤوا الى بيروت، الى الصفير تحديداً، وبات على أبي الذي لم يكن يتجاوز الخمس عشرة عاماً، أن يرعى العائلة الكبيرة لأكملها، فخرج يعمل تارة في الحدادة وتارة في تصميم اللافتات، ولم يتأخر قبل أن ينخرط في العمل المسلّح ضد الاحتلال الاسرائيلي، والحرب الأهلية لاحقاً. عندما تزوّج بأمي وولدتني، تعاركا كثيراً كي يتوقف عن حمل السلاح، ففعل بعد ليال طويلة من الانتظار والبكاء والخوف وأزيز الرصاص. وفي أيار 2000، حمل بارودته مرّة أخرى ليكون ورفاقه أول الداخلين الى ضيعتنا المحرّرة. يومها، لم تطلب منه أمي أن يترك السلاح، لكنها كانت تهاتفه كل خمس دقائق، بعينين دامعتين وابتسامة عريضة.
حاول أبي كل ما بوسعه طوال حياته وبوسائله القليلة التي يعرف، ليؤمن لنا “حياة أفضل من تلك التي عاشها هو“، بحسب تعبيره. عمل مرّة في التجارة فخسر بسبب ثقته العمياء بشركائه، وافتتح مرة أخرى محالاً لبيع الخضار ثم أغلقه لأنها ليست كاره، ثم افتتح محالاً للهواتف فخسر لأنه لا يعرف في المصلحة، وسافر سنة وعاد، وبين كل عمل وعمل كان يختبر البطالة لفترة من الزمن قبل أن ينتفض على نفسه ويلملم أجزاءه القوية المبعثرة، ويبتدع عملاً يقوم به. اليوم، عاد ليعمل بالتجارة.
لا أفهم هذا الحنين الممزوج بالأسى في عينيه عندما يسرد قصص حرب طاحنة قذرة بشعة تفوح منها رائحة الدماء حتى الغثيان، كما لا أفهم أمي عندما تصف أيام الحرب ولياليها في الملاجئ ب“رزق الله“. ربّما يحنّان الى الطفولة، وطفولتهما حرب أهلية، كما أحنّ أنا الى طفولتي، وطفولتي كثير من الأشياء، من بينها قصص الحرب الأهلية. يتحدث أبي عن تفاصيل المعارك كما أتحدث أنا عن تفاصيل مدرستي الأولى. تظهر على وجهه ابتسامة مبالغ فيها، ويعدل جلسته بحماس بالغ، ويبدأ بوصف بربور والمخيمات والشياح والضاحية والصفير ومكتبه ويخبر قصصا طريفة عن رفاقه، قبل أن ينتقل ليصف الحواجز والمواجهات وأنواع الأسلحة ورائحة الرصاص وقصص اعتقاله وقصة حبّه لأمي وكيف جاء بعشر ربطات خبز لأهلها أيام انقطاع الخبز، وكيف رافق أخيها القادم من أميركا من المطار حتى منزلهم في الروشة ليحرص على سلامته.
أتراه حين يسرد تلك القصص بحماسة، لا يفكّر بمن وقعت عليهم القذيفة، وان كانوا مقاتلي “الأعداء“، أو بمن سمعوا صوتها وهرعوا خائفين باكين الى ملاجئهم؟ في المرة القادمة، سأسأله.
تبدو على وجه أبي علامات الضيق عندما أسمّيها “حرباً أهلية“، أو أصفه ب“مقاتل في ميليشيا“، هكذا بصراحة فجّة. أشعر أنه في تلك اللحظة، يواجه حقيقة فاتحة فمها على وسعه مكشّرة عن أنياب بشعة، لطالما جاهد للهروب منها في السنوات العشرين الماضية. هو يسمّيها “أجبِرنا عليها للدفاع عن أنفسنا ومناطقنا“. أقفز عن كل هذه الذرائع والتفاصيل اليومية والمشاعر الفردية والأحادث السياسية “الكبرى“، أقفز فوق كل الرصاصات المتطايرة، مجدداً، وأصرّ أنها “حرب أهلية“. فيجيبني “أنا أقرب رفيق لالي مسيحي“، وكأنها بطاقة اعتماد للبراءة من الطائفية. أجيبه: “بترضى اتزوج رفيقي المسيحي؟“، يطرق بصمت يشوبه بعض الغضب والاحراج ثم يقول: “يا بابا، مين بياخد من غير ملّتو بيموت بعلّتو، أنا مش طائفي، بس المجتمع هيك، وأنا ما برضى تعيشي مقهورة“. أشعر برغبة في احتضانه، وبغضب عارم يدفعني لتفجير الحقائق القاسية كما هي في وجهه. لم أتصالح مع ماضيه بعد.
تخبرني أمي أنها دخلت المنزل مرة فرأته جالساً في ركن الصالون يتفرج على صور في يده ويبكي بحرقة، كانت تلك المرة الأولى التي تراه فيها يبكي. انتظرت خروجه وتناولت الصور، فوجدتها صوراً لأشلاء مقطّعة وقد كتب على كل منها اسم صديق له. وما زال حتى اليوم، عندما يذكر أسماء هؤلاء في معرض حديثه، يصيب الوهن صوته. أشعر بالأسى عليه وعليهم، لكني لا أقدر أن أتعاطف معهم وأنا أعرف ما فعلوا.
في عمر أصغر، كنت أستفزّه قائلة: “ان من ماتوا وهم يقاتلون ضد الطوائف الأخرى، ليسوا شهداء“، فينتفض مدافعا عن موت رفاقه، ليعلنهم أبطالاً أبرياء لم يكونوا في ساحة الوغى لحظة موتهم، انما قضوا برصاص طائش، أو في “كمين معدّ” وهم يلمّعون بواريدهم. يصرّ أبي دائماً أنه لم يقتل انساناً في حياته، ويلحق تصريحه ب“الحمد الله، كنت دائماً أقول أني لن أقتل أحداً كي لا يبتليني الله في أولادي“. أشعر برغبة في احتضانه، وبغضب عارم.
لم أتصالح مع ماضي أبي، لأن في ذهني أسئلة لا تنطفئ كلما فكرت في الموضوع. أنا لم أرَه مقاتلاً يوماً، ولا رأيته يحمل بارودةً، انما رأيته أباً مكافحاً، مضطهداً في كثير من الأحيان. لا أعرف من ماضيه سوى ما يخبرني هو به، وما ينقله اليّ رفاقه وعمّتي من بطولات وأخلاق رفيعة سطّرها في “الأحداث“. هل حقاً لم يقتل أحداً، ولو عن خطأ؟ هل حقّاً لم يضطهد أحداً عندما كان مشرفاً على أمن الحي، ومن ثم المنطقة؟ كيف كان الناس والأطفال يشعرون عندما كان يتنقل بسلاحه، ويركب “الجيب” مع رفاقه المسلحين من زاروب الى آخر؟ ربما لم يقتل، لكنه رافق ودافع عمّن قَتَلوا. أفكر أن أبي ضحية فقد شبابه وفرص علم وعمل وسلام هائلة، لكن هل من مجال للمقارنة بينه وبين من قتِلوا في ملاجئهم ومنازلهم، ومن فقدوا أحباء وممتلكات وأطراف في قصف عشوائي، ومن ما زالوا يعيشون آثاراً نفسية ويومية للحرب الأهلية التي لم يكونوا مشاركين فيها، عن حقّ؟ لا أسأله كثيراً عن تفاصيل كل شيء. لعلّي لا أريد أن أسأله.
“سحر” عاشت في منزل بحمام مفروش دائماً استعداداً للهروب المقبل، وحملت دلاء الماء من شركة المياه، ومشت في طفولتها في بيروت خالية ومظلمة الا من المتاريس وجور القذائف والمزابل والمباني المنهارة، واختبرت نقصاً في الطعام والشراب والدراسة والفرح وتخمة في الرعب، ولعبت ببقايا الرصاص وشاهدت جثثا مرمية أرضاً. “سحر” ما زالت تذكر السلاح الجاهز دوماً على خصور المسلحين المنتشرين المستعدين دوماً لتوقيف واحتجاز واهانة وقتل أياً كان، ويد أمها تغطي عينيها بعد كل خبر عاجل تتبعه مشاهد دموية كارثية. هل أخبره عما حدث ل“سحر” في طفولتها؟ لعلّه سيتعاطف معها ويحزن من أجلها، لكن هل سيدرك أنه ورفاقه و“أعدائهم” كانوا السبب؟ هل كانوا هم حقاّ السبب؟ فأمه وأخوته وأخواته عاشوا كما عاشت “سحر“. هل كان أبي مجرّد أداة تطلق النار، أم كان صانع قرار؟ من كان السبب؟
لو عادت الحرب، هل سيعود ل“يدافع عن المنطقة“؟ هو يقسم أنه لن يفعل، ولعلّه هذه المرة سيكون مشغولا بتجارة مربحة. ربما عندها، قد أصدق أنه لم يدخل الحرب في المرة الأولى بملء ارادته.
لين هاشم