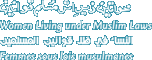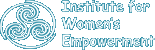سوريا: هل تستحق قضايا الأسرة محكمة خاصة بها؟
لعل الصياغة الإنشائية في هذا المشروع نجت أكثر قليلاً من سابقتيها من الاستدرار العاطفي. لكنها أبدت تخوفاً من الخوض في قانون الأحوال الشخصية غير مبرر، إذ تقول : إن "تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لا يعود كما يحلو للبعض أن يفسره لرغبة المنظمات النسائية بالخروج عن أحكام الشريعة، وإنما البحث عن حلول ضمن مظلة الشريعة ذاتها"!.
وإذ نقول غير مبرر لا نتناسى بعض الذين يعتقدون أنهم ممثلو الشريعة والقيمون عليها! وإن كان هذا من حقهم بالتأكيد، وكان يمكن أن تسهم غيرتهم في إبداعات لإيجاد حلول مناسبة لواقعنا، غيرة سبق لها قبل أكثر من ألف سنة أن أبدعت اجتهادات مناسبة لذلك الزمن. لكنهم فضلوا أن يبقوا حجر عثرة في سبيل تطوير المجتمع، هذا التطوير الذي شكل الغاية العليا لجميع الأديان السماوية منها والأرضية
ومرة أخرى لا نفهم لماذا علينا أن نكون موضع الدفاع كلما فكرنا في تطوير هذا الجانب أو ذاك؟ أو التساؤل عن هذه القضية أو تلك؟ أو البحث عن العوامل الأساسية في هذه المسألة أو تلك؟ لكأن الفكر والمجتمع باتا رهناً بإعلان صك البراءة من أي اتهام قد يخرج به أحدهم؟ في الواقع نعتقد أن هذا المجمتمع هو مجتمعنا. ورجال الدين، أيا كانت أفكارهم وآراؤهم هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. ولكن ليس من حق أحد، مهما كانت صفته، أن يصادر رأي الآخر. وأصلاً يفاخر رجال الدين أن الأديان السماوية هي أكثر من حض واعتمد على الفكر والحجة واستنكر ونفى الإكراه. فمن الغريب إذا أننا نلجأ الآن إلى الاتهامات التي تفتح الأبواب من الإكراه وحتى.. وننسى الأساس ذاك!
والواقع الذي تثبته كتب التاريخ أن الأولون في الإسلام أكدوا مرارا وتكراراً، وعاشوا تأكيدهم عملياً، على الفكر الحر والمحاججة. والمبررات التي تساق اليوم كاستناد إلى إنكار المحاججة هي مبررات تتعلق بنقاشات من مستوى آخر (تتعلق بالذات الإلهية وليس بالأحكام)، بل حتى هذه تنتمي إلى لحظة تاريخية خاصة كانت حاسمة في تاريخ الإسلام. وتم تجاوزها لاحقاً لينفتح باب النقاش على مصراعيه، وبالضبط تطابق زمن النقاش الحر هذا مع أفضل أزمان الدولة العربية. ونعرف جميعاً أن الأحكام المتعلقة بحياة البشر خضعت لنقاشات مستفيضة ودون أي تقييد، في زمن حياة النبي محمد وفي زمن الخلفاء من بعده وحتى اعتماد الدولة الدين وسيلة للحكم. إذ تم، بدءاً من ذلك، اعتماد رأي واحد وتفسير واحد واجتهاد واحد وأطلق التكفير والمحاربة على كل ما عداه!
نريد أن نقول أن قانون الأحوال الشخصية، لعله من أهم القوانين المتعلقة مباشرة بحياة الناس. ولا يمكن أن يكون هناك أي محظور في نقاش أي من بنوده، انتقاداً أو اقتراحاً. وما على الفكرة إلا أن تثبت نفسها بقوة العقل. فقد شبعنا فعلاً من قوة العاطفة.
ليس الاستطراد أعلاه من باب المناكفة أو الجدل السفسطائي. وكترجمة عيانية ملموسة لهذا، فإن مقدمة المشروع ذاته ذهبت لتقول: "من المعلوم أن الصحابة قد تزوجوا من أرامل لمصلحة الأم والأطفال لتتمكن من رعايتهم.. وهو ما لا نجده اليوم، ويستدعي ذلك تعديل بعض الأحكام لمصلحة الأم والأطفال لتتمكن من رعايتهم"!
لعل عاقلاً لايحاجج في مدى الكرم والشهامة التي مثلها هؤلاء الرجال الذين تزوجوا لهذه الغاية. ووفق السياق التاريخي لواقعهم ومجتمعهم يمكن القول أنه سلوك يستحق كل احترام. لكن هذا شيء، وأن نبني مشروعنا أعلاه بناء على أننا "لا نجد مثل تلك الحالة اليوم"، شيء آخر! هل الأمر هكذا حقاً؟ هل إن وجد اليوم من يتزوج النساء المطلقات والأرامل لأجل تأمين عيش أطفالهن، ينزاح عبء بحثنا عن حل لكل المشاكل المتعلقة بالطلاق والترمل والحضانة والرعاية و...؟! إذا كان الأمر كذلك، فعله من الأجدى والأقل تكلفة والأكثر سرعة أن نشجع على هذا السلوك بدلاً من سن قوانين نعرف أنها ستعاني الأمرين قبل أن تتحقق، ونعرف أيضاً أن الخاضعين والخاضعات لها سيعانوي المرّ مرات ثلاثة، إن لم يكن أكثر للحصول على حقوقهم! والواقع أن هذا المثل لم يكن يمكن أن يساق على هذا النحو لولا ذلك الخوف المزمن من الحديث في قانون الأحوال الشخصية! خوف لم نجد مبرراً له حتى بوجود البعض الذين يحاولون التخويف من أي خوض في هذا الأمر. ونعتقد جازمين أنهم قلة قليلة. ليس لاعتقادنا الأساسي أن الإسلام (والمسيحية واليهودية أيضاً) لم يكن يوماً ديناً للإرهاب، لا الجسدي منه ولا الفكري، فحسب، بل لمعرفتنا المادية الملموسة بعدد كبير من رجال الدين في سورية، ولعل عدداً وافراً من هؤلاء مدهشون حقاً بمدى انفتاح أفقهم على استخدام أقصى إمكانيات العقل (ذاك الذي ميز الإنسان عن الحيوان وفق جميع الأديان)! ولا نظن أنهم يعملون على تدمير هذا الدين أو ذاك "من الداخل"! ولعله من المفيد في هذا السياق أن نقول رأينا واضحاً دون مواربة: ليس بعض رجال الدين فقط هم من يستخدمون الإرهاب الفكري والتشويه والتخوين ضد من يخالفهم، بل أيضاً بعض ممن يعملون في قضايا المجتمع لا يقلون غلواً في اتهاماتهم لرجال الدين، وتعميم اتهاماتهم عن أولئك! وليس صحيحاً فقط أن الكثير من رجال الدين يعانون من امتلاك وإتقان الحوار مع المختلف، بل أيضاً الكثيرون من غيرهم يعانون المشكلة ذاتها، أي امتلاك وإتقان الحوار مع رجال الدين. وهذه المشكلة باتت واضحة ومقلقة. ولعله حان الوقت المناسب لرمي تلك المتاريس القديمة مرة واحدة وإلى الأبد. لم يخلو مجتمع من المغالين مهما كانت صفاتهم وعقائدهم والأفكار المدافعين عنها. وهؤلاء لم يشكلوا يوماً سوى أقلية. وما نحن بحاجة إليه اليوم حاجةماسة هو البدء جدياً في فتح أبواب الحوار على مصراعيها من أجل مجتمع أفضل. وعوضاً عن البحث وراء الكلمات والأفكار عن أيد غريبة (سواء غربية متآمرة أو شرقية إرهابية) يمكننا الاعتماد حقاً على الكلمات ذاتها والأفكار ذاتها ومناقشة مدى صلاحيتها من عدمه لمجتمعنا الراهن والمستقبلي.
ومن المفيد هنا أيضاً أن نقول أن المنظمات النسائية هي منظمات سورية، والقائمات والقائمين عليها وأعضائها جميعا ينتمون إلى هذ البلد. وهي معنية بقضايا المجتمع، خاصة المرأة منه، مثلما كل جهة أخرى، وأي جهة أخرى معنية بهذا المجتمع. ولا ميزة لغيرها عليها حتى تصير هي هدفاً دائماً للهجوم والاتهامات!
بعد هذا التقديم المطول نعود إلى مشروع قانون محاكم الأسرة.
قدم هدف المشروع الأساس على أنه تقديم محكمة صديقة للأسرة والطفل. وليس محكمة لا يعنيها سوى تطبيق قوانين في مجال تعقده المشاعر والعواطف والمصالح المتداخلة. وبالتالي الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية أثناء النظر في قضايا النزاع المتعلقة بالأسرة. والحفاظ على السرية والخصوصية الضرورية ضرورة ماسة في هذه النزاعات. كذلك التخلص من بطء الإجراءات ومراعاة مصالح الطفل بصفتها مصالح عليا في نتائج هذه النزاعات. ولذلك أشار المشروع إلى ضرورة تضمن تشكيل المحكمة اختصاصيين في علمي النفس والاجتماع، لمساعدة الأسرة على التوصل إلى تفاهم وحلول معقولة ومقبولة قبل النظر في داعوى الطلاق والتفريق. ولحظ المشروع ضرورة التدريب الخاص بجميع العاملين في هذه المحاكم. كذلك لحظ ضرورة توفر الخبرة في هيئة هذه المحكمة، من حيث ضرورة ترؤسها من قبل ثلاثة قضاة هم بدرجة رئيس محكمة بداية على الأقل. وطالب المشروع بإقامة نيابة متخصصة بشؤون الأسرة تتولى المهام المنوطة بالنيابة العامة في المحاكم الأخرى. كما طالب بإنشاء إدارة خاصة بكل محكمة أسرة مهمتها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها أو عن دوائرها الاستئنافية.
آراء المشاركون:
ناقش الحاضرون المشروع في صيغته المقدمة والمختصرة جداً. فأشار د. محمد واصل، دكتور في القانون، إلى أهمية إصدار قانون خاص يتعلق بالتوفيق والمصالحة قبل الطلاق. واشار إلى أن تطبيق هذه التجربة في بعض بلدان الخليج أدى إلى انخفاض نسبة الطلاق إلى نحو 75 % منذ تشكيل مثل هذه اللجان.
وأشارت د. كندة الشماط إلى وجود اتجاهين في هذا الأمر. أولهما هو إنشاء محاكم خاصة بالأسرة. والثاني هو تطوير المحاكم الشرعية الموجودة. أما القاضي سنان قصاب فأكد على أهمية أن تكون "محاكم أسرة" مستقلة وجديدة. وأشار إلى أهمية أن تكون امرأة قاضية بين هيئة القضاة الثلاثة في هذه المحاكم. كما اقترح أن يكون في اشتراطات تعيين قضاة هذه المحاكم أن يكون القضاءة متزوجون بسبب خصوصية التفاصيل المتعلقة بالنزاعات الأسروية وضرورة أن يكون القاضي يعرف آلياتها وما يشابهها في حياته العملية. مؤكداً على ضرورة أن يكون الدور الأول لمحكمة الأسرة هو البحث عن أسباب الخلاف وإمكانيات الحل والمصالحة. أما د. فاروق الباشا فرأى أن تطوير المحاكم الشرعية ذاتها قد يكون أفضل من استبدالها بمحاكم أسرة، مع تعديل في اختصاصها وآليات عملها. وعبر د. حسان العوض عن خشيته أن يكون وراء البحث في إنشاء محاكم أسرة هو الترويج للزواج المدني، وتسريب أحكام وضعية لا علاقة لها بالشريعة. وأكد أن المحاكم الشرعية الحالية تحتاج إلى إعادة بناء خاصة لجهة كونها تفتقد إلى المصادر الشرعية في عملها. وأشار إلى أن الكثير من أحكام قانون الأحوال الشخصية لا تطبق حالياً. وتساءل عن إمكانية أن يكون خريج كلية الشرعية مؤهلاً لتولي القضاء في المحاكم الشرعية بتأهيلهم عبر قسم خاص في معهد خاص بالقضاء الشرعي، أو عبر إنشاء قسم خاص في كلية الحقوق يعنى بالقضاء الشرعي.ولم ير د. العوض مانعاً من تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية على أن تنسجم مع الشريعة. وقال أن بعض الشيوخ الذين هاجموا الساعين إلى بعض التعديلات إنما فعلوا ذلك نتيجة غياب التنسيق معهم.
وعلق القاضي سنان قصاب مستغرباً التخوف من تسمية "محاكم الأسرة"! وعد التسمية مناسبة لمحكمة مخصة في جانب محدد. وقال أن المحكمة الشرعية تطبق القانون، لكنها لا تعنى بمصلحة الأسرة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى محاكم أسرة لا تهدف إلى تطبيق القانون وحسب، بل تعمل أولاً على أسباب النزاع ومحاولة حلها آخذة مصلحة الأسرة كاعتبار أعلى.
محكمة أسرة.. ولكن!
يبدو لنا أن ما قاله د. فاروق الباشا من إمكانية الاستفادة من الإيحاء "الروحي" لتسمية المحاكم الشرعية، مع تطويرها وتخصيصها وفق منطق ومنظور محاكم الأسرة، يستحق التوقف. ولا نرى مشكلة في التسمية بحد ذاتها. ولعل الاستفادة من الإيحاء الروحي ذلك تكون مفيدة حقاً. لكن هناك تخوفاً فعلياً من أن يلعب الاسم دوراً معاكساً لأهداف محاكم الأسرة وآلياتها. بمعنى أن تفرض التسمية، الإيجابية على المتقاضين، تفكيراً سلبياً على القضاة والعاملين فيها، من حيث استعادة آليات التفكير والعمل المرتبطة حالياً بالمحاكم الشرعية، والتي تعنى فقط بتطبيق القوانين. بل يمكن القول أن تعنى بتطبيق القوانين التي في مصلحة الرجل، وتمانع بوسائل متعددة القوانين التي في مصلحة المرأة. ولا نعتقد أننا بحاجة إلى إيراد أمثلة على هذا الانحياز. فهو أشهر وأعم من أن يحتاج إلى أمثلة.
ولكن لتسمية محاكم الأسرة إيجابياته أيضاً. فهو يؤسس لمنظور مختلف نسبياً عن المنظور الذي تكرسه تسمية المحاكم الشرعية. فهنا يمكن القول أن التسمية تلعب دوراً إيجابياً أيضاً باعتبارها تجسيدا واضحاً لمنظور هذه المحاكم، أي لاعتبار مصلحة الأسرة هي العليا، وتأخير تطبيق القانون حتى تستنفد إمكانيات الفرص الحقيقية لإبقاء الأسرة قائمة. وهي أيضاً تحمل مفهوماً مدنياً أساسياً في الحياة الراهنة. مدني بمعنى المواطنة وليس بالمعنى الذي ذهب إليه د. العوض في تخوفه. ومحكمة الأسرة، على كل حال، هي أمر منفصل عن القوانين التي ستعمل على تطبيقها. وليست معنية، بداهة، بسن القوانين أو تعديلها. ويبدو لنا أن "الروحي" هنا لا يتعارض مع "المدني". بل لعلهما يتكاملان ويتفاعلان أخيراً في خدمة الأسرة، بغض النظر عن التشوهات التي طرأت على كل منهما خلال أزمان مضت.
على كل حال، يبدو لنا أن المهم الآن هو مضمون المشروع. أي وجود محاكم مختصة بقضايا الأسرة مستقلة وتضع في اعتبارها الأول مصلحة الأسرة. ومعنية حصراً بالقضايا المتعلقة بها من طلاق وزواج وغيرها.. وهي باتت حاجة ماسة في ظل الواقع الحالي للمحاكم الشرعية التي تغص بآلاف المراجعين كل يوم! ولا تحفظ أية سرية لعملها. ولا تعنى أبداً بواقع الأسرة المعنية وإمكانيات الحل فيها. بل إن زيارة إلى غرف الاستماع التي يفترض أن تكون سرية، والتي يتم فيها الاستفسار عن الأسباب الداعية إلى الطلاق، أو حتى زيارة حتى بعد أمتار عن الباب المغلق، كافية لتعطي فكرة وافية عن واقع الحال! ليس فقط من حيث غياب السرية، بل أولاً من حيث المنظور الذي يجري فيه مثل هذا "الاستماع"!
وإذا كانت فكرة أن يتضمن القانون أن تكون هيئة المحكمة امرأة هي فكرة صائبة تماماً برأينا، فإن الفكرة التي طرحها القاضي سنان قصاب حول تضمين القانون نصاً يفيد بضرورة أن يكون القضاة الذين يشغلون هذه المحاكم جميعهم من المتزوجين هي فكرة رائدة بحق من وجهة نظرنا. والواقع أنها تنسجم كلياً مع الهدف الأساس من محاكم الأسرة، أي مع وضع مصلحة الأسرة كأولوية. فمن الصعب تخيل إمكانية تفهم الكثير من التفاصيل التي تؤدي، بطريقة أو بأخرى، إلى خلافات توصل إلى المحاكم، من الصعب تفهمها من غير المتزوجين. خاصة أن الحياة الزوجية أصلاً هي مسيرة غنية من التفاصيل الصغيرة. ويعرف المختصون أن هذه التفاصيل غالباً ما تكون البذور الأولى للخلاف الرئيسي الذي يودي إلى الطلاق.
وكذلك فإن الفكرة التي طرحتها السيدة فردوس البحرة، رابطة النساء السوريات، حول أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية قبل إنشاء محاكم الأسرة، هي فكرة صائبة من حيث الجوهر برأينا. فمن الصعب تخيل عمل صحيح وجيد لهذه المحاكم في ظل قانون أحوال شخصية يعاني مما يعانيه قاموننا من تمييز ساحق لصالح الرجل. ولا يأخذ أصلا الأسرة كمنظور أساسي في العلاقة الزوجية. إلا أن ذلك لا يجب أن يعيق تشكيل هذه المحاكم. فحتى مع وضع قانون الأحوال الشخصية الراهن، يمكن لهذه المحاكم أن تلعب دوراً هاماً، لكن الأهم أنه يمكنها أن تؤسس جيداً لمعرفة أعمق وأكثر دقة بالنواقص والثغرات في قانون الأحوال الشخصية ذاته. نظرا لأنها معنية بمصلحة الأسرة قبل تطبيق القانون. وبالتالي سيمكنها رؤية التعارضات بين هذه المصلحة وتلك القوانين على خير وجه. أو هذا ما يؤمل على الأقل.
إذاً، نرى أن تشكيل محاكم اسرة في سورية، ومنحها مستلزمات نجاحها من استقلالية كلية ونواظم عمل داخلية مناسبة، و"بنية تحتية" (أبنية وموظفين..) مناسبة يمكنه أن يساهم مساهمة فعالة في حل مشكلة اجتماعية هامة، سواء عبر ما يمكنها أن تحله من خلافات قبل أن تؤدي إلى وقوع الطلاق، أو فيما يمكنه أن تفعله لأجل "طلاق عادل" ومناسب لجميع أفراد الأسرة التي ما زلنا، جميعاً، نعدها "الخلية الأساسية في المجتمع