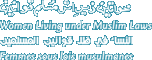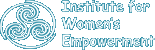أم الشهيد!

أم الشهيد".... مازلت أتحسس مكان نومك، لازالت أسمع صوتك المتقطع تأتي قافزا درجات السلم مسرعا "الغدا يا ماما بسرعة عايز ألحق مشواري"، شايفاك وانت بتتخرج، وانتا بتتجوز، لسه ملمس صوابعك على خدي وانت بترضع.
"أخت الشهيد".... تطلبه على هاتفه مائة مرة، لا يرد، تريد أن تلقن الأخ الأصغر -الذي لاعبته آلاف المرات وكسر كل دماها حين كانو صغارا- ما يقوله عن سبب تأخره خارج المنزل للوالد المنفعل، تعرف أنه في تلك المظاهرة أو المسيرة التي شاهدتها على التلفزيون، لكنه لا يرد.....
"زوجة الشهيد".... يا ترى هنعرف ندخل الولاد مدارس كويسة؟ طيب أنا هدخل جمعية علشان المدرسة التجريبي؟ واعمل حسابك الواد والبت هيتعلمو نفس التعليم. انت مش بترد عليا ليه؟ انت رحت فين؟
"بنت الشهيد"... بس أنا ما كلمتهوش يا بابا، هوا اللي بيمشي ورايا بعد المدرسة وبيحاول يكلمني، والله ما رديت عليه، انت مش مصدقني يا بابا، ما انت عارف أنا لو فيه أي حاجة في حياتي ما أنا بقولك... معقولة مش مصدقني، أنا هزعل لو مش مصدقني...
وتتداعي السيناريوهات في كل مرة أرى فيها وجوه أمهات، وأخوات، وزوجات وبنات شهداء الثورة المصرية المستمرة منذ 25 يناير 2011، وفي كل مرة أفكر، لم يردن أبناءهن وأحباءهن شهداء، أكاد أجزم بذلك. أردن أن يبقوا معهن، أرادته الأم "عريس" يختار فتاة أحلامه، أرادته الأخت معها في خطوات الحياة الصعبة، رغبت الزوجة والابنة شريكا في الأحلام، فأين ذهب؟
لقد ارتبطت الثورة المصرية في أذهان المتابعين بأنها ثورة سلمية لا دماء فيها، وهو ما ينيغي تصحيحه، فالمحاربات والمحاربون لأجل الحرية يتساقطون تباعا منذ 28 يناير 2011، تارة على يد شرطة مبارك، وتارة أخرى في مواجهات لحماية مواقع الثوار في ميدان التحرير فيما يعرف بــ "موقعة الجمل"، وتارات كثيرة مع عسكر يحاولون باستماتة أن يحافظوا على "عسكرة السلطة" في دولة يقود شبابها أمواج المطالبات بدولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية، ولا يتخير الموت في كل مرة من يستهدف ولكنه يفاجئنا باختيار أن يغيب أولئك الشباب الحالمين.
ومع كل جنازة لشهيد، تطول قائمة "أمهات الشهداء"، ومع كل مواجهة ترداد أعداد المقبوض عليهم والمحاكمين، ليتجاوز الرقم الآلاف، وتزداد عذابات الأمهات، فأي عنف أبشع من سرقة الوليد من حضن أمه، تراه يموت أمامها تحت عجل مدرعة جيش، أو خلف قضبان سجن حربي لا تدرك لما دخله فهو مدني لا علاقة له بالجيش أو العسكر، أو أنه غائب لا تعرف مكانه أو مصاب لا تعرف أي مشفى أو طبيب يخفف آلامه، لأن الروتين المصري العتيد لا يعينها على علاجه.
أم "خالد السعيد"، ذاك الفتى ساكن المدينة الساحلية الذي قتله عنف الأمن وأتخذ أيقونة للثورة المصرية، هي مثل أم "بوعزيزي" في تونس الشاب الذي أشعل النار في نفسه يأسا من حياة حرمته العيش الكريم، هي زوجة ذلك الشيخ ذو الابتسامة الوديعة "عماد عفت" الذي قتل في مواجهات مع قوى الأمن التي استقوت بسلاحها على شباب رافض للمارسات التعسفية القمعية من هذه القوات، هي أخت الشاب "مينا دانيال" الذي أعجز لليوم عن النظر لصورته فضحكته تذكرني أن مجتمعنا الذي يدعي التكاتف قد تخلى عن مواطنيه على دين المسيح بكل صلف وغرور، هي أم "رانيا فؤاد" الطبيبة الشابة التي اختنفت بالغاز المسيل للدموع حين كانت تسعف المصابين في المستشفى الميداني في مواجهات الثوار مع قوات الأمن....وفي كل شهر منذ يناير 2011 نفقدهم، ليزداد عدد الأمهات اللواتي يقضين يومهن غائبات في ذكرياتهن مع الغائب أو الغائبة، أو بجانب فراشه أو في السعي لإطلاق سراحه.
تحصد الرصاصات، والأسلحة أرواح الشباب، يموتون في مستشفيات غاب فيها التجهيز، فالدولة لعهود طويلة تصرف ملايين الدولارات على التسلح وتقطر على التعليم والصحة، يختنق الشباب من الغاز المسيل للدموع من قنابل، تدفع أمهاتهم ثمنها من الضرائب التي تسدد للدولة من دخل الأسر، وإن لم تقتلهم أصابتهم في صميم صحتهم. تقف الأمهات بالساعات في شرفات البيوت تنظر للسماء أن يعيد الشاب الذي وعدها ألا يشارك ولكنها تدرك تماما من عينيه التي أدارها بعيدا حين سألته، أنه سيشارك. ربما هي مريضة، يرتفع ضغطها أو تؤلمها تلك الخشونة في ركبتيها كحال معظم المصريات ، لكنها لا تستطيع أن تستريح قبل أن تعود "البت مقصوفة الرقبة" أو "الواد اللي ضحك عليها".
وأنا أكتب السطور السابقة في محاولة للتنفيس عن غصبي، جاءتني مكالمة بعيدة من صديقة سودانية استشعرت الغضب في ردي على أحد مكاتباتها الالكترونية، "ما بك؟"، شرحت لها غضبي من حزن هؤلاء النساء: الأمهات والأخوات والزوجات والبنات "لما عليهن أن يحزن، لم يخترن ذلك، كيف ستكمل حياتها وقد غرز الألم في قلبها، ليس من البطولة أن تكون حزينة، أشك أنها ترغب في ذلك"...صمتت لدرجة تصورت أن الخط قد انقطع، أقفلته فعاودت الاتصال. "تدرين في الحرب مع جنوب السودان، كان جيش البشير يقتل الشباب في الجنوب، ثم يقدم المال من ممثلي حزبه لأسر القتلى لإقامة سرادق عزاء كبير احتفالا بالشهادة، وتعظم الأمهات حتى يتصور الجميع أن هذا هو الأمر العادي، أن يقتل الشباب". أدرك تماما معنى أن ترى اسم عزيز عليك في قائمة "الشهداء"، صديقة طفولتي الفلسطينية كانت في قائمة أسماء شهداء الانتفاضة الثانية، قتلها الجيش الاسرائيلي، كدت أخسر ثانية في سنوات الحصار على العراق، وفي كل يوم من أيام الثورة المصرية أكاد أخسر آخرين، أقاوم الرغبة ألف مرة في إبقائهم بعيدا عن الخطر، لتبقى العبارة الخالدة "العمر واحد والرب واحد"، لكن الألم أقسى من كل وصف، فمال بال ألم هؤلاء الأمهات، فلا تبرر الشهادة أبدا العنف ولا السلطان الغاشم الذي يغتال الحلم ويخلق كل هذا الألم.
لا يخشى الشابات والشباب الموت في ساحات الحرية، الموت هي الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذه الحياة، يريدون أن يحيوا وقوفا، لكن من يعزي الأمهات. أكاد أجزم أن صورة أمها أو أمه تكاد أن تكون الصورة الأخيرة التي يراها قبل أن يسلم عينيه أو عينيها لثبات أخير، يحادثها "سامحيني كنت عايزها حلوة ليا وليكي".
بقلم دعاء عبد العال ، ناشطة مصرية، وعضو مجلس إدارة شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين.